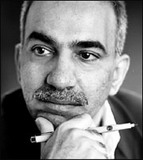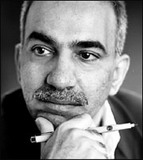كان مثنى كالمصعدْ |
يهبطُ… |
يصعدْ…! |
لكنَّ مثنى قرَّرَ أنْ يتوقَّفَ عن هذا التعبِ اليوميِّ، |
المللِ المُتكرِّرِ.. |
أنْ يَفتَحَ نافذةَ القلبِ على البحرِ المُزْبِدْ |
أنْ يركضَ، يركضَ، حافي القدمين، على العُشْبِ الناعمِ |
أنْ يتمدّدْ |
أنْ ينسى كلَّ عواءِ السَيَّاراتِ… |
ضجيج المدنِ الملغومةِ بالآلاتِ، وبالأضواءِ |
موسيقى الديسكو، الإعلاناتِ |
اللهث وراءَ اللُقمةِ |
صافرة الشرطيِّ، |
أنين المصعدْ..! |
ومثنى… |
لمْ يسكرْ في بارٍ |
لمْ يختلسِ النظراتِ لساقِ فتاةٍ في سُلَّمِ باصٍ |
لمْ يَسرِقْ تيناً من بستانِ أحدْ |
ومثنى لمْ يَدخُلْ مدرسةً |
ويُصدِّق أنَّ الأرضَ تدورُ |
وأصلَ الإنسانِ "من القِرْدِ".. |
وما خبّأ تحت وسادتهِ قمراً مجنوناً |
أو أُغنيةً لـ "أم كلثوم" |
أو ديناراً من شغلِ الأمسِ |
ولمْ يبكِ على ما فاتَ |
ولمْ يحقدْ… |
ومثنى… آهٍ |
أَضْبَطُ من رَقَّاصِ الساعة |
في الثامنةِ المعتادةِ يذهبُ للشغلِ |
وفي الثانيةِ المعتادةِ يرجعُ للبيتِ |
وبين الشغلِ، وبين البيتِ |
أضاعَ مثنى عنوانَ النهرِ، الصَحْب، |
الأشجار، |
وضيَّعهُ الأصحابُ |
ومقهى يرتادون |
وشقراء.. لمْ تجنِ منه سوى الخجلِ القرويِّ |
وسَلَّةِ تمرٍ، وحكاياتٍ بيضاء… |
فعافتهُ وحيداً |
مُحتَرِقَ الأجفانِ أمام الشُبّاكِ الموصدْ |
ماذا لو يسترخي الآنَ أمامَ النافذةِ المفتوحةِ.. |
طولَ الصبحِ.. |
ويتركُ هذا الجرسَ الأحمقَ.. يقرعُ حتى… |
ماذا لو يذهبُ للبستانِ – كما كان مع الأصحابِ – |
ويجمعُ بعضَ السعفِ اليابسِ |
يشوي ما اصطادَ من الأسماكِ.. على الجرفِ |
ويأكُلُ حتى التخمة… |
ماذا لو… |
يركضُ خلفَ فَراشاتِ طفولتهِ الغافيةِ الآنَ |
على أكمامِ الوردْ… |
ماذا لو ينسى – لدقائق – أنَّ العالمَ |
مشحونٌ بالأتعابِ.. |
وبالدُخَّانِ الأسودْ |
ماذا لو....... |
........ |
لكنَّ مثنى، وهو يُفكِّرُ أنْ يوقفَ سيرَ المصعدْ |
يسرعُ نحو الشغلِ – كعادتهِ – |
يجلِسُ خلفَ الطاولةِ المتآكلةِ الأطرافِ |
يُفكِّرُ بالترفيعِ..، |
وخمسةِ أفواهٍ زغبٍ |
وحياةٍ كالريحْ..! |
* * * |
6/5/1984 الكوفة |